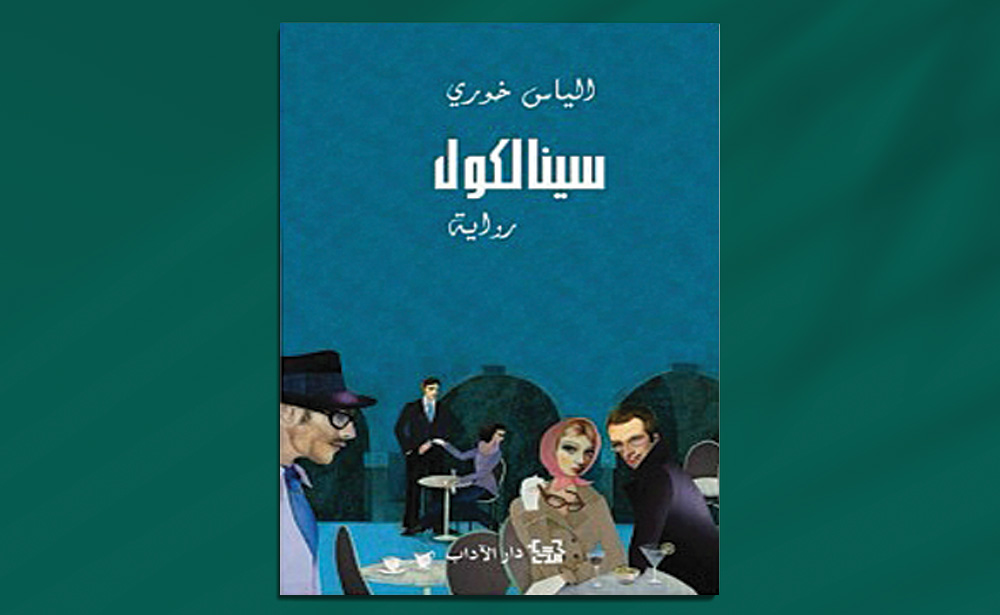نوال الستيتي
باحثة فلسطينية
لعل الروائي الذي يسجلُ أحداثًا تاريخية يصوغُ تاريخًا مكتوبًا، يتهمُ فيه سلطة أيِّ مستبدٍ، ويسائلُ تاريخًا قد يتغافلُ عن كتابته المؤرخون، ذلك لأنّ الجنس الروائي يحيلُ إلى التاريخ، فالتاريخُ كثيف الحضورِ في الوقائع التي عايشها الروائيُّ.
وهذا ما نلحظه في رواية “سينالكول” لإلياس خوري، التي رصدتْ أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، مسجلةً تفاصيل تعكسُ طبيعة الصراع الديني والسياسي الذي كان السبب في اندلاع هذه الحرب. فلا يمكنُ إنكار العلاقة بين الرواية والتاريخ؛ لأنّ الرواية تستعرضُ الحياة اليومية بكل مشاكلها وتفاصيلها وقضاياها وشخوصها، وهذا جزءٌ من التاريخ الذي لم يكتبه المؤرخون، كما أنّ التاريخ عبارة عن أحداثٍ وأشخاصٍ وتفسير ورؤية، والرواية كذلك1. فالحرب الأهلية التي عاشها إلياس خوري، وكوّنته فكريًا، جعلتْ من رواياته في الحرب اللبنانية وثيقةً تُسجلُ بعض أحداثها، وربما أراد خوري في روايته هذه أن يقررَ أنه لا يكتبُ رواية عن الحرب فحسب، بل عن سيرة عائلةٍ تعكسُ أقدارها مصائر الحرب، فلو شاء الحرب موضوعًا خالصًا لروايته، لكان عليه أن يلتزمَ بتعاقبٍ زمنيٍّ أكثرَ دقةً، وهو ما لا نجده في الرواية، فتعاملَ الروائي مع زمنين: زمنٍ تعاقبيٍّ بسيطٍ مكوناته ميلاد الحرب وشبابها وكهولتها، وزمنٍ إنسانيٍّ أكثرَ تعقيدًا يتضمنُ الميلاد دون أن يتضمن الشباب والكهولة، وهو الزمن الذي يدل على انعكاسات الحرب العميقة وامتداداتها على المجتمع اللبناني، ولا نبالغ بالقول إنها ما تزالُ مستمرةً إلى وقتنا الحاضر، حيث يمكن التنبؤ بالزمن الأول، في حين يبقى الثاني عصيًّا على التنبؤ. وقد عمل إلياس خوري بدقةٍ تُقاربُ البحث العلمي على تحديد السنوات والشهور وحتى الأيام أحيانًا، دون أن تفوته أحوال الفصول المتناوبة، وتبدلات المكان واضطراب الأفكار والمعايير والعادات، فسجّل زمن بداية الحرب الأهلية، وأبرز الأطراف المشاركة فيها، إضافة إلى الدور الإسرائيلي والسوري في لبنان، والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني اللاجئ.
فقد عثر إلياس خوري على وثيقته الأدبية، وهي حشدٌ من الشخصيات والمصائر، تقومُ في أسرة ” نصري الشماس” وولديه “كريم” و”نسيم” التي تعيش في بيروت، وقد خلق وثيقته من عناصر متكاملة: المكان، ومتابعة الأحداث التاريخية. فإلياس لم يقع على رواية الحرب هذه “سينالكول”، إلا ليرى فعل الزمن في الحرب، وفي الشعب اللبناني الذي استظل بحربٍ لم يسهم جزءٌ كبير منهم في اندلاعها، ولعل هذه الحرب جعلت من إلياس الكاتب والشاهد، الذي ينتج الرواية والشهادة، فالروائي يشهد كتابةً على ما يعيشه الآخرون، ولا يحسنون كتابته، منددًا بما ينددون به، ناظرًا إلى أفقٍ مرغوبٍ ينتظرونه. فـ”سينالكول” تسائلُ فترةً محددةً من تاريخ لبنان، وهي في خيارها المحدد بزمانه ومكانه وشخصياتٍ منه، تذهبُ إلى الوثيقة التاريخية، وتعيدُ كتابتها بشكلٍ آخر، فيتوجه خوري إلى قارئه راجعًا به إلى الماضي وإلى مكانٍ وأحداثٍ لا يخطئها أحد، فبداية الرواية هي الحد الفاصل بين ما جرى، وما كان بإمكانه أن يجري، بين الوقائعي والمتخيل، أو بين بداية المؤرخ وبداية الروائي الذي يقبل بالأول ويتجاوزه.
بين يدي الرواية
صدرت رواية “سينالكول” لأول مرة (ط 1، 2012م) و(ط 2، 2014م) عن دار الآداب للنشر والتوزيع في بيروت، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013 المعروفة باسم “جائزة البوكر العربية”.
«مزّق الرسالة ورمى بها أرضًا فوق نثار الزجاج المطحون، أغمض عينيه، وجلس في عتمة روحه، وقرّر أن معانقة العتمة في مدينة تشبه بيروت تقود إلى الموت، وفكّر أن هذا الموت يصلح لرواية يكتبها إلياس خوري»2، ينهي إلياس خوري “سينالكول” بهذه الكلمات، فتبدأ الرواية بأحداثٍ تنطلق من بيروت عام 1990م، لتعود في رحلة زمنية إلى بداية الحرب الأهلية اللبنانية، متنقلةً جغرافيًا إلى فرنسا، لتقوم على مجموعة من الثنائيات المتناقضة، التي ترمز إلى ما يعانيه لبنان بسبب الطائفية التي جعلته على ما هو عليه، ومن الثنائيات: (كريم، نسيم)، (لبنان، الهجرة)، (الحياة، الموت)، (الشجاعة، الجبن)، (الحب، الجنس)،(الشمال، الجنوب)، (الرجل، المرأة)، (سورية، إسرائيل).
وغيرها من الثنائيات التي تُشكل كل مشاهد الرواية المكونة من (506) صفحات، تبدو كحلبة صراع متنازعة يريد كل طرف أن يثبت وجوده على حساب الآخر.
تبدو عائلة “نصري الشماس” المحور الرئيس للأحداث، “فنصري” الصيدلي الأرمل الذي لم يتزوج مرة ثانية؛ ليتولى رعاية ولديه «كريم» و«نسيم»، و يشكل معهما ثلاثيًا مقدسًا يرفض أن ينفصل أحدُ أضلاعه. غير أن الحرب تعبث بهذا الثالوث المقدس، فتفصل بين أضلاعه مع الوقت، “فكريم” الذي يدرس الطب في الجامعة الأمريكية، ينحاز إلى اليسار، وينضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية، أما “نسيم” فيبقى في الأشرفية، وينضم لحزب الكتائب المسيحيّ، ما جعل أباهما “نصري” يصرخ بقوله: ” شو هالعيلة، واحد عامل شيوعي، والثاني كتائبي فاشستي، مش ناقص إلا تقتلوا بعض، حتى نصير حكاية”3.
وتستمر حكاية الخلافات بين اللبنانيين في الحرب الأهلية، بين مَنْ يريد المحافظة على مصير مسيحيي الشرق بالتحالف مع إسرائيل، وبين مَنْ يرى أنّ لا حلَّ لمشكلة الأقليات إلا بالعلمانية، إلا أنّ ما حصل في الواقع يخالفُ رغبة كلا الطرفين، فقد نمتْ الحركات الأصولية الإسلامية على حساب اليسار العلماني، وذلك بعد التدخل السوري، وتهور اليمين اللبناني الذي أخطأ في تحالفه مع إسرائيل، التي استخدمته وسيلة لمحاربة الفدائيين الفلسطينيين، وارتكاب المجازر البشعة في حقهم.
وهكذا انتهت الرواية في العتمة التي تغرق فيها مدينة تشبه بيروت، لا بيروت نفسها.
يُصدّر إلياس خوري الرواية بالأسطر الآتية: «الأحداث والشخصيات في هذه الرواية هي من نسج الخيال، وإذا وُجد أيّ تشابه بين أحداثها وشخصياتها وبين أحداثٍ وشخصياتٍ حقيقية، فهذا من محض الصدفة، ومن صنع الخيال»4، إلا أن القارئ يدرك بعد قراءة الرواية أن معظم أحداثها وشخصياتها واقعية، وأن التشابه بينها لم يكن محض صدفةٍ، وإنْ حاول الكاتب تجنب ذكر الشخصية باسمها الحقيقي، كدلال المغربي الفدائية الفلسطينية التي تظهر باسم “جمال”، والتشابه يظهر في شخصيات أخرى سيتم الحديث عنها لاحقًا من هذا الفصل، ويظهر أيضًا بين الكاتبِ خوري والبطل في الرواية “كريم”، فكلاهما شارك في الحرب الأهلية، وانضم إلى حركة فتح، واليسار فيها، إضافة إلى علاقتهما بأبي جهاد، والكتابة”5، وربما كان حضور خوري في هذه الرواية الأكثر وضوحًا عن غيرها من الروايات، فهو على ما يبدو حاضر في أحداثها وفي الآراء السياسية التي ظهرت فيها، وإنْ حاول نفي هذا الأمر.
يُلحظ عند الوقوف على الشكل الروائي أن الرواية تُقسَّم إلى أربعة عشر قسمًا متفاوتةً في طولها، أقصرُ قسمين هما القسم الأول والأخير، وقد جاءت بعدد الصفحات نفسها، وهي أربع عشرة صفحةً، أي بعدد الأقسام كلها.
ويبدو أن هذا التقسيم لم يكن عشوائيًا، الأقسام الطويلة هي التي تُروى فيها تفاصيل الحرب، والسارد الرئيس سارد عليم، إضافة إلى صوت “كريم”، وتُسمعُ أصوات الشخصيات الأخرى، إلا أن أغلب الأحداث المسرودة تتمحور حول “كريم”، الذي كان ينتقل بذاكرته ما بين الماضي والحاضر، فقد اتصف سرده بالحكايات المتوالدة.
ويمكن حصر محاور الرواية بالنقاط الأربع الآتية:
مقاومة الموت
التفكك
البحث عن الأمان
تجربة اليسار اللبناني
فالمحور الأول يظهر حين يقرر “كريم” ترك بيروت هربًا من الحرب وويلاتها إلى فرنسا، بالإضافة إلى غيره من الشخصيات التي بقيتْ في لبنان، تحاولُ البحث عن الأمان بمقاومة الموت، بعضها رأت في الانضمام إلى أحد الأطراف المتنازعة وسيلة للهرب من هذا الموت.
بينما يتكشفُ في المحور الثاني ” التفكك”، فيظهرُ أول ما يظهر في الرواية من خلال التفكك الذي يحصل بين الشقيقين “كريم ونسيم” اللذين ليسا توأمين، وإنْ عاملهما والدهما على أنهما كذلك، فالأول وُلد في بداية العام والثاني في آخره، مما يجعل أباهما يتباهى برجولته لكونه حقق هذا الانجاز.
لكنّ الأخوين اللذين كانا يتشاركان الأحلام نفسها، ويشكلان مع والدهما أضلاع المثلث حول الطعام والشراب وحكايات النساء، حين كانوا يجتمعون معًا حول وليمة الأحد، تفرقا، فقد شوّهتْ الحرب كل شيء، فالأب اختار أن يقبل انطفاء بصره، و«كريم» اختار أن ينمّي حاسة اللمس عنده عندما اختار معالجة الأمراض الجلدية، وانصرف “نسيم” إلى شم المخدرات وتجارتها، غير أن الثلاثة اجتمعوا على لذة شرب الكحول والنساء.
ويتعمق الفراق بينهما حين يعشقان امرأة واحدة هي “هند”، فيهاجر “كريم” إلى فرنسا حيث يتزوج امرأة فرنسية، ويتزوج شقيقه نسيم “هند” التي كانت مغرمةً بأخيه.
ويتضح المحور الثالث “البحث عن الأمان” في حكاية المجتمع اللبناني المنقسم على ذاته، غير المتصالح معها، والهارب من ذاكرته إلى ذكريات الآخرين من فلسطينيين وسوريين وأحفاد صليبيين، كل فريق تحالف مع طرف من الأطراف دون الآخر، معتقدًا أنه السبيل في تحقيق أمانيه وطموحاته ليشعر بالأمان والاستقرار، وهذا ما افتقده لبنان وما زال.
وتشغل تجربة اليسار اللبناني حيّزًا واسعًا من الرواية، وذلك لأنها تمثل تجربة الكاتب نفسه، الذي انضم إلى اليسار وانحاز إلى الفلسطينيين وقضيتهم.
فـ”سينالكول” عنوان الرواية كلمة إسبانية تعني “من دون كحول” وفق شرح زوجة “كريم” الفرنسية، وقد كان الاسم الحركي “لكريم” حين كان يقاتل مع الأحزاب اليسارية في طرابلس، لكنه حين يعود إلى المدينة، كما يظهر في القسم الثالث عشر منها، فيلحظ كيف أن الإسلاميين قد سيطروا عليها، وبعضهم كانوا رفاقه في الصراع ضد سيطرة الفكر الديني، فيكتشف أن المدينة باتت تجمعُ عددًا من المتناقضات، ففيها أمراء الدين الذين كانوا يحاربون الدين كالشيخ “رضوان”، الذي قاتل مع “كريم” في صفوف اليساريين، وفيها المتشبث بماضٍ لم يبقَ منه سوى القلاع والقبور وبعض الأحياء القديمة الفقيرة، كأبي أحمد الدكيز الذي يُصرُّ على أنه من أحفاد الصليبيين الذين أسلموا، وآخرون يعيشون مُتحدِّين كل هذه التغيرات.
يكتشف “كريم” بعد عودته إلى لبنان بناء على دعوة أخيه من أجل مشروع المستشفى أنّ الأمور لم تستقمْ في لبنان، وأن الحرب على ما يبدو لم تنتهِ، فيقرّر العودة إلى عائلته الفرنسية، والهرب من جديد، خاصة حين يسمع تهديد صديقه اليساري القديم والمتدين حديثًا الشيخ “رضوان”، وهو يطالبه بأوراق “يحيى” التي تعود إلى زمن الثورة.
وكذلك حين رأى أخاه “نسيم” يصطحبُ أولاده إلى الكنيسة كل يوم أحدٍ بعدما توقّف عن المتاجرة بالمخدرات ومعاشرة العاهرات، ويدافع عن عون الذي يعده وريث بشير الجميل، ويتوقع أنّ يعيد للمسيحيين ثقتهم بأنفسهم6، وذلك بعد أن يحقق النصر ضد سورية واتفاق الطائف.
فيعود “كريم” إلى زوجته الفرنسية البيضاء؛ لينسى بين ذراعيها ذكرياته مع “هند” التي صارت زوجة أخيه، و”جمال” التي قضت في عملية فدائية في فلسطين، وليمحوَ بحياته الفرنسية الهادئة كل مغامراته البيروتية الصاخبة مع “منى” زوجة المهندس الفخور بمشروعه الساعي إلى تغيير معالم العاصمة ضمن مشروع إعادة الإعمار، ومع الخادمة “غزالة” التي اكتشف من خلال علاقته بها أنه ذاق طعم الخيانة لأول مرة في حياته. في يوم ميلاده يتوجه “كريم” إلى المطار هربًا من الحرب التي غيّرت كل شيء، فتبدو شخصيته أكثر تعبيرًا عن اللاانتماء إلى مدينة لا تشبه بيروت، التي يغتالها أهلها وهم يخوضون حربًا آثارها ما تزال باقية إلى أيامنا هذه.
الخاتمة
خلصت الباحثة في دراستها النقدية لـ«سينالكول»، إلى أنها تمثل وثيقة تاريخية ترصد أحداث الحرب الأهلية اللبنانية، وأنها تندرج في خانة روايات الحرب لخوري، الذي استطاع أن يبرز أبرز أحداثها، متحريًا الدقة في رصدها وذاكرًا باليوم والتاريخ بعض أحداثها، كونه شاهدًا عليها، بل مشاركًا فيها إلى جانب طرف من أطرافها، فاستطاع أن يكون ناقلًا أمينًا للتاريخ اللبناني، حين اعتمد على أحداث وشخصيات حقيقية، وإن لجأ إلى لعبة التلاعب بأسماء بعض الشخصيات، إلا أن صفاتها والمعطيات حولها سرعان ما تكشف عن حقيقتها، فيعرف القرّاء من تكون بناء على هذه الصفات.
وفيما يخص الكيفية التي نقل بها الروائي أحداث الحرب، نجد أنه اعتمد المعمار الأسلوبي نفسه، الذي اعتمده في روايات سابقة، باستخدام أسلوب السرد المتداخل الذي يعتمد على توالد الحكايات والإكثار من التكرار، حيث أضحى هذا الأسلوب الذي أخذه من التراث القصصي العربي ميّزة يتصف بها أسلوب خوري في معظم رواياته.
كما لجأ إلى تقسيم الرواية إلى فصول تتفاوت في طولها، حيث تُسهل على القارئ فهم رسالة الرواية ورؤية كاتبها.
ويجد المتتبع لأعمال خوري الأخرى في الحرب، نفسه أمام موضوعات مشتركة بينها وبين “سينالكول”، كونها تسجل أحداث الحرب عينها، إلا أن “سينالكول” اتسمت بخصوصية الكشف عن ثقافة الشعب اللبناني وعاداته بصورة جلية، فيتعرف القارئ على ثقافة طعام اللبنانيين وطقوسهم الدينية وشتائمهم وتعابيرهم اليومية الشعبية، بالإضافة إلى الكشف عن مواقف مختلفة لهم من الحرب الأهلية، بحيث يمكن تبيان أبرز الآراء والمواقف السياسية التي تبنتها الأطراف اللبنانية المختلفة، فقد عبّر خوري عن آرائه وهو يختفي خلف بعض الشخصيات.
كما ساهمت اللغة المستخدمة في “سينالكول” في عكس حقيقة المجتمع اللبناني الذي تنتمي إليه شخصيات الرواية، فلجأ إلى المزج بين الفصحى والعامية المحكية، التي جاءت من صميم اللهجة اللبنانية، دون أن يتحرج من استخدام الألفاظ النابية، مما أضاف إلى الرواية المصداقية.
وفيما يتعلق بتصوير الآخر قدّم خوري في رواياته صورة مختلفة عن الفلسطيني والفرنسي والخليجي والإسرائيلي، جاء بعضها صورة نمطية عُرف بها هذا الآخر كالخليجي، وبعضها بناء على معايشة مباشرة معه كالفلسطيني الذي يعيش في لبنان، وكان له حضور بارز في الكثير من أحداث تاريخه المعاصر.
الهوامش
(*) أجزاء من دراسة أطول.
ينظر دراج، فيصل: « الرواية وتأويل التاريخ». ط1. الدار البيضاء. المغرب: المركز الثقافي العربي. 2004م. ص 132
خوري، إلياس: «سينالكول». ط2. بيروت. لبنان: دار الآداب للنشر والتوزيع. 2014م. ص 506
المصدر نفسه. ص 141
السابق، ص 7
ينظر الأسطة، عادل: «أسئلة الرواية العربية، أولاد الغيتو،اسمي آدم إلياس خوري نموذجًا». ص 47
خوري، إلياس: «سينالكول». ص 488