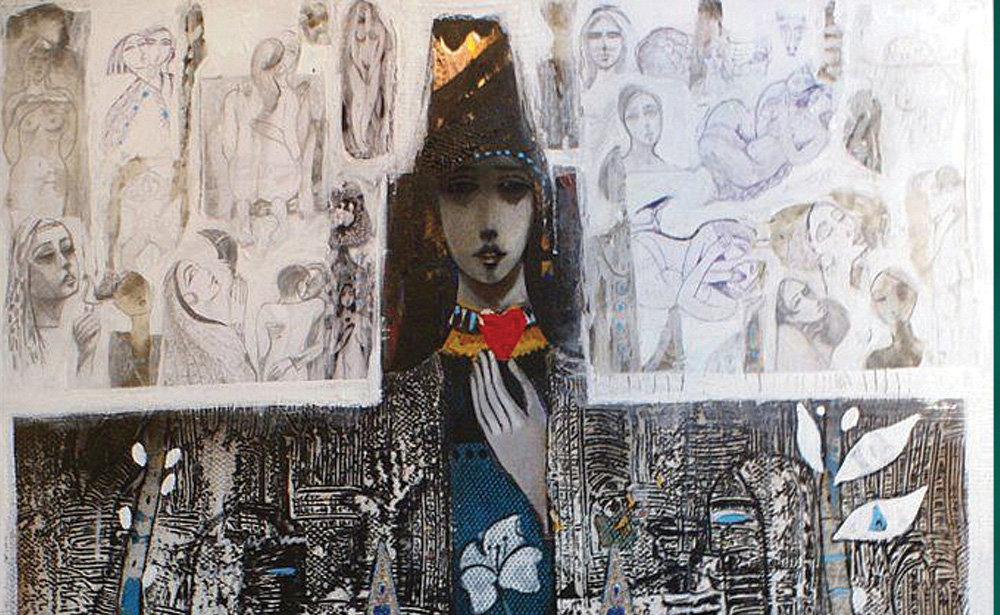في مقاله (من العمل إلى النص)، يأخذنا رولان بارت إلى عالم من التحولات التفكيكية، التي تنطلق من فكرة العلاقة النسبية بين النص والقارئ والناقد، باعتبارها علاقة ذات (وضع تعاقبي) قائم على (الإنتاج) وفق حقول منهجية، تتَّخذ من (العمل) (مختبرًا للنص)، فهو نص كائن بفضل العمل؛ أي فعل الأداء، وهذا يعني أن فضاء العمل يمثِّل كينونة المتخيَّل وإمكانات تشكُّل النص، ليعبِّر عن تاريخه الفكري الخالص القائم على تلك العلاقة.
إن النص بهذا المعنى هو “ما يدفع بقواعد التعبير إلى حد العقلانية القرائية” –بحسب بارت–، الأمر الذي يفسِّر قدرة النص على الانفتاح والإنتاج أو إعادة الإنتاج، وبالتالي منطق النص هنا يقوم على سلسلة من التشابكات والترابطات والتجاوزات وبناء العلاقات الرمزية بين مجموعة من الأنماط التي تجعل منه مرحلة انتقال بين الواقع والتخييل والبناء اللغوي لمحاولة تأسيس تجربة فريدة لا تتعلَّق بالنص باعتباره وحدة مستقلة بل بكونه فاتحة تأويلية للتعمق في الفكر.
يحاول النص في مراحل تشكُّله التعالق مع مجموع الفعل الكُلي للثقافة، الذي يتأسَّس من التجربة التي يُطلق عليها بارت (العمل). إنه الكُلي الدالّ على الوجود والضرورة، التي تجعل من الواقع والتعالق بين أنماط الحياة والخطابات المتطورة والآراء المتشاكلة، نتاجًا يظهر في وسائل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الجماهيرية بشكلٍ جليٍّ، ضمن حقول النص وتأويلاته، وتصوراته، ووجوديته، وفق ما يُطلق عليه فرانسوا جوليان (المشترك الحقيقي، والمتشابه المزيِّف).
إن هذا التعالق لا يشكِّل اختزالا للواقع والتطورات الثقافية والتقنية وحسب، بل يمنح الكلّي المتشاكل شرعية ثقافية تقوده نحو التحقُّق باعتباره ظاهرة؛ فالخطابات الثقافية اليوم تجعل من النصوص المنتجَة أفعالا متحققة، تقود المضامين إلى ما يسميه بارت (التعددية التجسيمية) للدوالّ، التي تجعل منه منسوجًا من تجسيمات منفتحة على مستوى التاريخ والتأويل، وعلى مستوى التركيب القائم على المنظور الحيوي المتطوِّر، الذي لا يقوم على الترميم النصي فقط، بل أيضا على إنتاج الخطابات الجديدة المنطلقة من الممارسة الفعلية للحداثة بوصفها عملًا يختزل المعرفة.
ولهذا فإن قابلية قارئ اليوم، وتفاعله تبدأ من قدرة النصوص على إنتاج الفكر المغاير، القائم على اختزال الممارسة وتمثيلها في انزياحات لا تظهر في لغة النص بقدر ما تبرز في تأويلاته وانفتاحه على عالم مليء بالتنويعات الكاشفة لجوهر النص ثقافيًا، ليكون النص بذلك كُلاًّ يعبِّر عن تلك التعالقات الفكرية والفلسفية والتاريخية واللغوية للثقافة التي ينتمي إليها في شكلها المتطوِّر والمتغيِّر، ويقدمها باعتبارها معرفة حداثية، تشكِّل جوهر المجتمع وهُويته الراسخة، وتحولاته وانزياحاته الفاصلة بين مرحلة ثقافية وأخرى.
إن هذه التحولات التي تبرزها النصوص بأنواعها وأشكالها المختلفة، تتيح المجال لإعادة التصورات لوظائف الثقافة في انزياحاتها وتماهيها مع وظائفها البنائية والتصنيفية، التي تتجاوز الاختلاف إلى التنوُّع، بُغية إتاحة الفرصة لتأسيس مسافات فاصلة بين الثقافات ومقابلة هُوياتها وفقا لتصورات الكينونة وفضاءات التجلي القائمة على فكرة الوجود والانتماء.
ولهذا فإن النصوص التي تُنتجها ثقافاتنا تنطلق وفق ذلك التصوُّر إلى إنتاج علاقات وتكوينات، تحاول خلالها تشكيل مسارات للامتداد الثقافي الذي أسَّسه الأجداد، وفق ما يسميه ميشيل توماسيللو بـ(العناصر القصدية)، و(العناصر العقلية)؛ وهي التي تمثِّل مراحل الانتقال الفكري للثقافة باعتبارها كونًا اجتماعيًا قائمًا على الأفكار والمعتقدات وطرائق تمثيلها في الخطابات النصيِّة، التي تعتبر أصولًا للمعرفة والتفكير، وتحليل التفاعل بين الثقافات في مراحل تغيُّرها وتطوُّرها المنبني على تلك المؤثرات التقنية الحديثة والتطورات الفكرية، ومقاصد الحالات الذهنية للمجتمع.
ولعل فهم انزياحات النصوص أيًا كانت (كتابية، أو بصرية، أو سمعية أو غير ذلك)، يشكِّل قاعدة رئيسة في سبر تجلياتها وتعاقبها ضمن الخطابات النصيِّة، للتفكير في تلك الكينونة التي هي إحالة كائنة تنقلها إلى المتلقي باعتبارها هُوية ثقافية، معبِّرة عن مفاهيم معرفية للتفاعل الاجتماعي مع النصوص الثقافية مثل (اللغة، والتاريخ، والفكر وغيرها)، والتي تُعد مكوناتٍ تنتج ضمن تلك الخطابات، غير أنها تنفلت منها إلى انزياحات قابلة للتأويل وفق ما يسميه أمبرتو إيكو (الأثر المفتوح).
فالأثر المفتوح (النص أو العمل المفتوح)، ذلك الأثر الذي يجذبنا نحن القُّرَّاء إلى الاستمتاع بالقراءة، ويحفزنا على بناء علاقات تفاعلية مع مجموع المثيرات التي يقدمها لنا النص وفقا لنوعه، الأمر الذي يعزوه إيكو إلى “كوننا نعطيه تأويلًا ونمنحه تنفيذًا ونعيد إحياءه في إطار أصيل”. إن هذا الانفتاح يجعل من النص عملًا قائمًا على الفكر الثقافي؛ فعلى الرغم من أن التأويل (لا يفلت من رقابة المؤلف) –حسب إيكو في الأثر المفتوح–، إلاَّ أن القارئ يستطيع حسب ثقافته وإمكاناته المعرفية أن يغوص في ثنايا النص ويشكِّل متواليات تأويلية ضمن فضاءات النص المختلفة، وفقا لما يُسمى بـ(التفاعل الحُر للقارئ).
وانطلاقا من ذلك فإن النصوص وفقًا لانفتاحها وخطاباتها، تتأثَّر بالمعطيات والمتغيرات التقنية التي أصبحت جزءًا أصيلًا من تكوينها المعرفي، وتحقيق وجوديتها وتكويناتها القائمة على الكينونة المعرفية المنتمية إلى الفعل الاجتماعي باعتبارها ممارسة دالّة على الثقافة، وهي بذلك تشكِّل بعدًا معرفيًا جديدًا على المستوى الدلالي للنص، وعلى مستوى الانفتاح التأويلي، كونها نصوصًا تُولد في فضاءات عامة، وتتعاطى مع ثقافة جماهيرية، لها أنماطها المعرفية المتنوعة، والتي قد تنتج تشابكاتٍ وتداخلاتٍ وتعالقاتٍ جديدة ما زالت ترزح ضمن مفاهيم (حدود الانتماء)، و(الخصوصية).
إن تلك الفضاءات والتعالقات تحاول من خلال النصوص، كشف المظاهر المعرفية للثقافة، بُغية إنتاج أو إعادة إنتاج الترابطات الدالة للأفكار والقيم والمعارف، وابتداع فكر جديد لا يغاير الواقع الاجتماعي بقدر ما يحاول إنتاجه ونسجه في عالم من المتغيرات التقنية، ولهذا فإن النصوص المكتوبة بشكل خاص تقدِّم نفسها بوصفها حالة من تلك التعالقات، لتكون وفقا لذلك إمكانًا منفتحًا على عوالم الفضاءات التقنية، مستفيدة منها في ترسيخ فكر الانفتاح والتجانس النصي مع الصورة واللون بل وحتى الصوت.
ولأن المجلات الثقافية كانت وما زالت تمثِّل أفقًا متجليًا لتلك الفضاءات، لما تمثِّله من كينونة تحيا ضمنها النصوص، وتقدِّم لها عالمًا مكانيًا وزمانيًا؛ أي وحدة كونية تقودها إلى فعل التعاقب والتوالي، فإنها تشكِّل هُوية وجودية لتلك النصوص، تكشف عن عوالم الثقافات التي تنتمي إليها، وتنطلق ضمن فعل القراءة إلى جماهير قادرة على الانفتاح والانزياح وفقًا للعلاقات التي تنشئها مع النصوص، التي تستطيع (التنبؤ بقارئ نموذجي مؤهَّل لتجريب حدوسات لا نهائية) –حسب إيكو في حكاياته عن إساءة الفهم–.
إن فعل القراءة هنا قائم على كفاءة القارئ، ولذلك فإن النصوص تقدِّم نفسها باعتبارها تعالقات ثقافية تربط بين المعرفة، والفكر، والقدرة على التجلي، بواسطة اللغة بشكل خاص (أيًّا كان نوعها)، لتعبِّر عن نفسها باعتبارها (وجودًا) له تأثيراته وأسئلته وتجلياته وقدرته على الانفتاح، ولهذا فإن قدرة مجتمع ما على تسويق نصوصه الثقافية، والتعريف بها في محيطه الاجتماعي والثقافي العام، يسهم في تقديم تصورات إدراكية بشأن الفعل الثقافي والفكري في المجتمع.
ولعل الدور الفاعل الذي قدمته خلال أكثر من ثلاثين عامًا، يشكِّل أساسًا معرفيًا لإنتاج النصوص أو إعادة إنتاجها، الأمر الذي جعلها إمكانًا معرفيًّا للانزياحات والتنوعات النصيِّة، وفق عوالم التفاعل والسياقات الاجتماعية والمعرفية التي أنتجت النصوص وأسهمت في تمثيلها وإنتاج تحولاتها التفكيكية على مستوى الكاتب والناقد والقارئ؛ إذ قدَّمت المجلة خلال مراحل تطوُّرها الفكري والمعرفي، مجموعة من التحولات التي أسهمت في إعادة إنتاج النصوص وإعادة بنائها وتشكُّلها، وتتابعها، وأصبحت إمكانًا للتعريف بالعديد من الثقافات والهُويات، والتكوينات المتعالقة من تلك الثقافات في العالم.
ولقد كان لها الدور الكبير في تأسيس حالة ثقافية فريدة منذ تسعينيات القرن الماضي، انطلاقا من التصورات الثقافية التي قامت عليها باعتبارها ذات كينونة منطلقة من الانزياحات الخصبة المرتبطة بجوهر الثقافة الوطنية والعربية ومنها إلى أنساق ثقافات العالم، وقدرتها على التجلي في أنماط معرفية لا تتجسَّد في قوالب النصوص وإمكانات انفتاحها وحسب، بل أيضا في تلك التجارب الإنسانية التي تشكِّل بعدًا معرفيًّا قائمًا على العلاقات الثقافية البينية، والتي نشأ في ظلها الشاعر سيف الرحبي مؤسِّس المجلة، وكذلك الشاعر زاهر الغافري الذي تحتفي به المجلة في عددها الحالي باعتباره حالة ثقافية لها جوهرها المتفرِّد الذي يعبِّر عن فلسفة تعالق النص وانزياحاته المعرفية وانفتاحه وفق (حركة متسلسلة من الانفكاك والتشابك والمتغيرات) -بتعبير بارت-.
إن هذه النماذج النصيِّة التي قدمتها وتقدمها ، لا تنحصر ضمن آفاق الفضاءات الحديثة وقدرة نصوصها على تقديم حالات الاغتراب والاقتراب من الواقع المعرفي العُماني وحسب، بل تكمن في الدور الطليعي الذي قدمته المجلة منذ نشأتها، في تجلي الثقافات العربية والعالمية عمومًا، والعُمانية خصوصًا، من خلال نصوصها التي مثَّلت حالة من التشابكات والتداخلات على مستوى المدارس الثقافية والمنهجيات التي عبَّرت عن ذاتها نصًا وفكرًا وصورةً، ووجودًا اجتماعيًا لمجموع الفعل الكلي للثقافة، وقدرتها على التعالق مع مرجعياتها التي تعبِّر عن مقاصد الخطاب الذي تنتمي إليه.
ولهذا فإن المجلة اليوم وقد أسَّست مفاهيمها وأصولها المعرفية، فإنها تنطلق أو تحاول الانطلاق نحو تتبُّع خطابات ذات أبعاد معرفية جديدة، تتناسب مع تطورات النص نفسه، وقدرته على الانفتاح إلى عوالم لا متناهية في إطار ما يسمى بـ(الوضعية التجريبية)، التي حفَّزت النص إلى الانفلات من رِبقة المعهود إلى الغوص في عوالم التقنيات والتفاعلات التي تتعاضد أو تتقاطع مع عوالم الواقع المعيشي أو التاريخي؛ إذ أُنتجت النصوص أو أُعيد إنتاجها، وفقا لحالات الإدراك ومقتضيات التمثيل الجديدة؛ فتشكَّلت أنواع جديدة من التعالقات الثقافية وأشكال مغايرة من التجانسات والسيرورات التي تقدِّم النص ليس باعتباره كونًا مستقلًا بل اتساعًا فكريًا قائمًا على الممارسة أو فعل (العمل).
عزيزي القارئ، إننا إذ نقدِّم بين يديك هذا العدد من مجلة ، باعتباره كونًا ثقافيًّا منفتحًا، فإننا ندعوك لأن تكون فاعلًا في تشاكلات نصوصه، متعالقًا مفكِّكًا لها، قادرًا على الولوج إلى أعماقها وسبرها، وفق المرجعيات الثقافية التي تؤسسها.